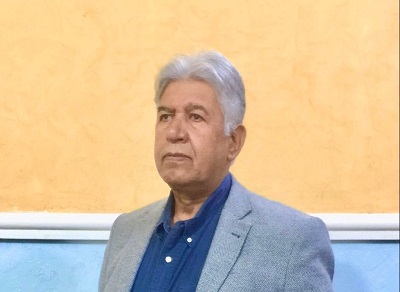* بيتر هارلنغ /لوموند ديبلوماتيك
إذا كان الهدف الفعلي لاجتياح العراق عام 2003 من قبل الولايات المتحدة هو السيطرة على النفط، كما تؤكده الوثائق التي رفعت عنها السرية مؤخرا، فإن العملية أفضت إلى فشل ذريع. أضف الى ذلك أن الحرب أوقعت مئات آلاف الضحايا، وزعزعت الدولة. وخلف قناع تطبيع غريب، تستمر التوترات السياسية والمذهبية في بغداد. بعد أعمال عنف أودت بحياة الآلاف من البشر، ولم تترك أحدا تقريبا من دون قصة مأساوية يحكيها، استقر العراق في حالة تطبيع جديدة،
لكن من دون أن يكون على بينة من الوجهة التي يأخذها، ومن دون مساعدة العراقيين على استقراء المستقبل. هكذا يتساءل أحد الروائيين، وهو بالتحديد يحاول فهم الأمور: “كيف يمكن رواية السنوات العشر الأخيرة؟ ليست المشكلة في نقطة الانطلاق، بل في نقطة الوصول. فمن أجل كتابة تاريخ حرب الجزائر، تطلب الانتظار حتى انتهائها. أما هنا، فنحن ما زلنا في سلسلة متلاحقة من الأحداث، لم يلح بعد شيء من نهاياتها”. وحتى بنية الرواية التي يعمل عليها، والتي يروي كل فصل من فصولها حكاية بالنسبة إلى أحداث سنة محددة، تجعله مرتهنا لنظام سياسي لايزال يطالعنا بالمفاجآت المشوقة.
بعد مضي عشر سنوات على الاجتياح الأميركي، الذي أنهى حكم صدام حسين، لا يزال العراق رهن أزمته. لكن للاطلاع على ذلك، تعتبر بغداد المكان الأخير الذي تجب زيارته. فالاعتداءات الدموية التي من دونها لا يكاد يذكر هذا البلد في وسائل الإعلام، أصبحت نادرة في العاصمة نسبة إلى السنوات القليلة السابقة، عندما كانت مقاومة الاحتلال والميليشيات الطائفية تعتمد السيارات المفخخة والانتحاريين والقنابل الأخرى من مختلف الأنواع.
حركة السير في بغداد تتحسن بعد أن أضحت كابوسا بسبب انتشار نقاط التفتيش والمعوقات الاسمنتية. والعراقيون الذين هربوا، في عام 2006 خصوصا، من أعمال العنف ولجأوا إلى كردستان أو خارج الحدود، يعودون بأعداد كبيرة. والذين “تعاملوا” مع الولايات المتحدة استعادوا مواقعهم العادية في المجتمع، وغلاء المعيشة لا يمنع الكثير من الجماعات الجديدة التي استفادت من الخيرات النفطية من الإغراق في عملية استهلاك مسعورة. كما أن النشاط يبدو أكثر حيوية في الشوارع التجارية منه في كواليس عالم السياسة، حيث يبدو أن شخصيات من كل الاتجاهات تتعاطى مع آخر موضوع خلافي بشيء من إهمال المتعودين.
المالكي “القوي”.. معزول
مناهضو رئيس الوزراء السيد نوري المالكي يتكاثرون بمقدار ما يعمل هو على فرض نفسه على أنه “الرجل الأقوى في البلاد”. وقد استفاد المالكي كثيرا من الكباش بينه وبين القيادة الكردية التي تسيطر على شمال شرق البلاد، حول توزيع العائدات النفطية وتابعية الأراضي المتنازع عليها، من أجل استقطاب بعض الدعم في أوساط السكان العرب، الشيعة والسنة على حد سواء، طارحا نفسه مدافعا عن مصالحهم، وبشكل أعم عن الوحدة الوطنية. لكن ها هو يسرف في استغلال حجة “الإرهاب” لكي يقصي بعض رجالات السياسة مثل السيد رفيق العيساوي، نائبه السني الملتحق بلائحة شيعية في ظل نظام سياسي يستند على توزيع المناصب على أساس إثني-طائفي. ومذاك قامت تحركات شعبية واسعة وحدت الساحة السنية ضده، مما جعل تكاثر التظاهرات يرغم بعض الشخصيات السياسية المتعاونة مع السيد المالكي على الابتعاد عنه…
وينتج عن ذلك تلقائيا تقريبا حالة انقباض شيعية انتمائية، في مجتمع ما يزال يعيش تحت صدمة أعمال العنف الطائفية التي استشرت خصوصا بين العامين 2006 و2008. ولذلك ليس للسيد المالكي فقط حلفاء في الدائرة الشيعية التعددية، ذاك أن قوته الشخصية تتضخم مع الحد من تأثير منافسيه على طريقة الأواني المستطرقة.
بالتالي، يجد رئيس الوزراء نفسه معزولا بشكل غريب. فهو ضعيف في مواجهة الأكراد، مما أعاده إلى لعبة مذهبية، وهو واثق في الوقت نفسه من خطوطه الخلفية الطائفية التي حاول أن يترك مسافة معها بلعبه ورقة القومية. لكن تبقى في يديه بعض أوراق القوة، مثل سيطرته على موارد الدولة، وعجز خصومه المختلفين معه عن التوافق على خلف له. وتقوم حالة غريبة من التوافق الأميركي – الإيراني على الحفاظ على الاستقرار قبل كل شيء (الأميركيون يريدون تناسي فشلهم في العراق، والإيرانيون يخشون أن يفاقموا خسارتهم في سوريا)، وربما يكون من أقوى العوامل هذا المبدأ المحكم من الانتهازية السوداء التي يقوم عليها النظام السياسي، إضافة إلى حالة إرهاق شعبي يمكن أن يمنع أي تحرك.
وبالعكس، ليست المواجهة مستحيلة نظرا إلى حجم الإحباط في الوسط السني، وحالة الاستقطاب المذهبية التي نتجت عن ذلك، والقصور المادي والمعنوي لجهاز أمني غير مؤهل لمواجهة التمرد ويفتقر للشرعية الوطنية. إذ ليس من المستبعد إذاً أن يأتي سيناريو معين تتولد فيه حالة فراغ سياسي يؤدي الى تعطيل حركة السيد المالكي أو حتى يرغم فيه على الاستقالة من دون الاتفاق على خلافته.
من ناحية أخرى، يبقى من الصعب تحديد طبيعة النظام. فرئيس الحكومة يتبع منطقا لا يقصر خصومه في شجبه على أساس أنه استبدادي، إذ هو يستأثر بالسلطات التنفيذية لدرجة أن مجرد طلب تأشيرة دخول إلى البلاد قد تمر بمكاتبه. ويندرج أسلوبه كشخص فائق القوة يتمتع بالرجولة في سياق تقليد عريق لايزال العراقيون حساسين تجاهه. وفي ظل مسؤولياته، تتكرر عمليات انتهاك حقوق الإنسان وفق قواعد تذكر بالسياق الجهنمي للنظام السابق. لكنه على الرغم من كل شيء يواجه حالة تعددية باتت متجذرة وتكاد تطيح بكل طموح توهمي نحو الاستبداد.
يتعارض نفوذ السيد المالكي في الوقت نفسه مع ظهور حياة برلمانية فعلية، ويستند بالأحرى على ضبابية قواعد اللعبة السياسية كأرضية لإعادة توزيع مرنة للموارد وللتحالفات في جو من النزاعات الدائمة. هكذا يرى السيد عادل عبد المهدي، نائب الرئيس سابقا، أنه “لم يعد مسموحا أن يقوم نظام يسيطر فيه مذهب أو حزب أو شخص. لقد حاول السنة ذلك، وللشيعة أن يجربوا أيضا، لكن هذا لن ينجح. كما أنه لا يمكن في هذا الطور أيضا الرهان على نظام يعتمد على مواطنية متحررة من الطائفية. فالتعددية واللامركزية وحتى الفدرالية هي حالات لا بد منها في الطور الحالي. لكننا لا نتبع اليوم أي نظام سياسي محدد. والمؤسسات تعمل بشكل سيئ، والدستور لا يطبق فعليا”.
التركة الأميركية
هذا الوضع هو واحد من بعدين حددتهما بشكل فائق التركة الأميركية في العراق. فما بين اجتياح اعتبر “عملية جراحية” من دون تحمل تبعاتها، وانسحاب متسرع برغبة من الرئيس باراك أوباما “كان الهدف منه التبرؤ بأسرع ما يمكن من التعهدات غير المناسبة التي أطلقها سلفه جورج بوش”، شهد الوضع سنوات من التفنن السياسي الذي يستحق، في أفضل الأحوال، تسمية الارتجال. ولننتقل إلى الخطايا الأصلية، مثل تجريم بنى النظام السابق وتفكيكها كليا، والنظرة المذهبية إلى النظام السياسي، والترويج حصرا لسياسيين منفيين منقطعين عن المجتمع، والتفاوض في الكواليس على دستور يعكس اتفاقا بين الشيعة والأكراد على حساب السنة، والإكثار من الانتخابات التي تكرس تهميش هؤلاء السنة.
كان بالإمكان إصلاح كل هذه الأغلاط بتأن؛ إلا أن الولايات المتحدة أخطأت بنوع خاص في إهمالها لذلك. فقد جاء انسحابها، على عكس الأهداف التي حددتها هي لنفسها، من دون أي اتفاق على مجمل المشاكل التي ستبقى قائمة في العراق لوقت طويل، ومنها إعادة النظر في الدستور، وتحديد سيادة الأراضي المتنازع عليها، وتوزيع الثروات والعلاقات بين السلطة المركزية والمقاطعات وصلاحيات رئيس الوزراء ومأسسة السلطات المعارضة وعمل البرلمان داخليا وبنية الجهاز القمعي، إلخ. ظل كل شيء بحاجة إلى تفاوض وإعادة تفاوض، من أزمة سياسية إلى أزمة سياسية أخرى، بحيث يبقى عدم الحسم مستبطنا كليا لدى الأشخاص المعنيين. وهذا ما يلخصه أحد المستشارين المقربين من السيد المالكي، قائلا: “إن الاضطرابات التي نمر فيها هي التعبير الطبيعي عن الظروف غير الطبيعية. فنحن لا نزال نواصل مسيرتنا الانتقالية”.
الشق الثاني من التركة الأميركية يتعلق بالتوزيعة الكيانية، العرجاء والناقصة، التي يتخبط فيها العراقيون مؤقتا. وإذ أسبغت الولايات المتحدة نظرة بدائية على المجتمع، وإذ ألصقت بالعراقيين مفاهيم فظة من البعثية أو “الصدامية” أو الإرهاب أو المذهبية أو القبلية، وإذ أقامت بنية سياسية مؤسسة على الشعارات، فقد جعلت من العراق صورة هزلية عن نفسه. تذكر هذه الظاهرة بالتأثير الكمالي للمتخيل الاستعماري، وإن لم يكن الاجتياح الأميركي قد رمى بأي شكل إلى “الاستعمار” بالمعنى الدقيق للكلمة.
فالمحتل عندما عامل السنة على أنهم جميعا مؤيدون لصدام حسين، وإنهم وحدهم ضد الولايات المتحدة، تسبب بتهميشهم في النظام السياسي، ودفعهم إلى التأسف على عصر عانوا منه هم أيضا. أما في الساحة الشيعية، فقد أراد الأميركيون أيضا أن يروا فيها “أبرارا” و”أشرارا”، معمقين بذلك انقساما طبقيا من خلال إبعاد الحركة البروليتارية المسماة “الصدرية”، المتهمة زورا بتبعيتها لطهران. والأكراد أنفسهم بدوا وكأنهم حلفاء طبيعيون، معززين بذلك نزعتهم الاستقلالية وطموحاتهم على الأراضي المتنازع عليها.
مجاهرات انتمائية
هكذا بقي العراقيون في ناحية ما أسرى صورة مكونة عن أنفسهم صنعتها الولايات المتحدة، وخلفها الأميركيون وراءهم. وفي الواقع، تبقى الهويات التي تبرز بأشد ما يمكن من العلانية في غالب الأحوال كاريكاتورية. فالإسلاميون من كل المشارب يجهرون بانتمائهم الحصري عبر أسلوبهم للالتحاء، لحية قصيرة أو طويلة، مع أو من دون شوارب، ومع حلق باقي الشعر أو لا. وقد أخذ الجنود ورجال الشرطة عن “شركائهم” الاهتمام المتأنق بـ “مظهرهم”، وهو ما يترجم، في الموضة العراقية بحماية الركب التي تلبس دوما من فوق الكاحل. وكل أحياء بغداد تقريبا تعرض بكثرة ما يميز الانتماءات، مثل صور “الشهداء” والأعلام والكتابات على الجدران، التي تبين من دون أي لبس محتمل انتمائها الطائفي، الذي بات متجانسا. ولم تعد مؤسسات الدولة، للأسف، في منأى عن هذه الظاهرة، في بلد انكفأت فيه الرموز الوطنية وراء شعارات أكثر خصوصية. بالتالي نجد بعض الرايات الشيعية ترفرف على معظم حواجز المراقبة في العاصمة.
كما أن الخطابات موسومة بالتبسيطية المذهبية نفسها، التي لم تكن غائبة عن المجتمع ما قبل عام 2003، بل عن الحيز العام. وقد بات التعبير اليوم علنيا عن الأفكار المسبقة المتبادلة. وبعيدا عن الكلام الاصطلاحي اللامتناهي الذي كان يصدر فيما مضى عن الأخوة الوطنية، لا يستغرق أي متكلم نختاره عشوائيا سوى بضع دقائق لكي يسقط الأقنعة، ويتهم المتظاهرين في غرب العراق بأنهم خليط من البعثيين وعناصر من القاعدة وعملاء مندسين، وليحكم بأن “لكل عصر رجاله والآن جاء دورنا، نحن الشيعة لكي نحكم”. ولا تختلف عن ذلك أعلام المعارضة وأغانيها؛ إذ إنها حركت في البداية مرجعيات مرتبطة بالنظام القديم وبثقافة جهادية وبذهنية الثأر الطائفي. وفي الغالب ليس هذا السجل الموروث من نوع ممارسة الإيمان، بقدر ما هو من نوع الاستفزاز المجاني؛ لكن ذلك لا يهم، إذ إن الاستعراضات الكيانية لكلا الفريقين تأتي لتؤكد الأفكار السائدة لكل منهما.
وما يجسد حالة الانقسام بين الخطاب التعزيمي والممارسات الفعلية نجد رجل أعمال سنيا متزمتا، يدعو إلى أن تكون التظاهرات مذهبية كليا وذات طابع عنفي على الأخص، ثم لا يكلف نفسه حتى متابعة نشرة الأخبار… لأنه لا يهتم بالموضوع في العمق. كما أن الصداقات المستدامة تساعد في تحقيق حالات تقارب مهمة، فأحد المثقفين الذي أصبح إسلاميا معتدلا ومن مؤيدي المالكي، يصلي في مقر الحزب الشيوعي.
وفي الإجمال، هناك عوامل كثيرة يمكن أن تخفف من المبالغات الانتمائية الأكثر حدة، وما يلزم لكي تظهر هذه التغييرات بشكل أوضح هو القليل من الوقت والهدوء والاسترخاء. فالذي يخيم على المدينة هو شبح “الأيام السود” أو “الأحداث المذهبية”، أي أعمال العنف الداخلية في الغالب التي تحاول العبارات التخفيفية أن تزيلها. ولدى كل شخص ترتسم خارطة الأماكن المألوفة والمطمئنة، و”الداعمة”، والمناطق المخيفة حيث لا يتجرأ البعض على العودة إليها. وسكان الأحياء التي باتت آمنة يتعجبون من سمعتها الخطيرة في أوساط أولئك الذين لا يزورونها، ويعكسون مخاوفهم الخاصة على مناطق أخرى هي بدورها صار يسودها الهدوء. هذه المسافة المتروكة وهذا الإنكار نجدهما أيضا على الصعيد السياسي، إذ تبقى الزيارات نادرة إلى المناطق التي تصنف في المعسكر الخصم. كما أنها أساس للعبة السياسية ودافع لهاـ ولا تقصر على إثارة المخاوف عند الآخر والتشنجات الكيانية، وكذلك سجل كامل من حماية مصالح الجماعات.
حياة مرتجلة وبدون تنمية
وفي انتظار التطبيع الفعلي المنتظر على أحر من الجمر، يرتجل العراقيون حياتهم اليومية، ويتوجهون بشكل لافت في متاهات نظام سياسي ملتبس، ومجتمع مضطرب، ومدينة مفككة، واقتصاد معقد بألف شكل وشكل من التعقيدات الشائكة. فمثلا تتغذى معظم المنازل من ثلاثة مصادر للطاقة الكهربائية: من الشبكة الحكومية لبضع ساعات يوميا، ومن مولد خاص في الحي، ومن مولد صغير عند الحاجة لمواجهة القطع المتكرر؛ وذلك في سياق تنظيم فوضوي بدلا من أن يكون حسن الترتيب.
وقد عم المشهد أيضا الفساد عند نقاط التفتيش التي لم يعد هدفها أحيانا سوى الابتزاز. وفي هذا البلد الذي تعود الانفصامات والفظاظات، تستمر اللغة الوطنية في الاغتناء بكل المفردات اللازمة من أجل إبراز كل ما هو جديد وتدجين العبثي، من مثل كلمة “حواسم” التأسيسية التي لا ترجمة لها، وهي مشتقة من اللغة الدعائية لصدام حسين في عام 2003، والمقصود بها في الأساس هو مفهوم “الطابع الحاسم”، لكنها دلت مذاك على الكثير من التصرفات الجرمية التي أمكن حصولها في الفوضى القائمة. كما أن لروح الفكاهة مكانا في ذلك. إلا أن هذه الروح الخلاقة لا تخلخل أبدا مقاومة المعايير القديمة التي يبدو العراقيون متعلقين بها أكثر من أي وقت مضى. فعناوين محلات الحلوى الجيدة لا تزال هي نفسها، ولم تبطل موضة المقاهي المعروفة. أما الطعام التقليدي، مثل طبق السمك المشوي، المسقوف، فهو يتحول إلى نوع من الهوس.
والمخيف أكثر هو موقف الطبقة السياسية، التي تأقلمت مع الوضع بدلا من أن تحاول تغييره. فكأنما النظام الجديد قد انسل في لباس النظام السابق. والمسؤولون يقيمون في المقرات الفخمة التي كان فيها أسلافهم بعد أن استملكوها غداة سقوط عصر أرادوا وضع حد له. وفي بغداد، لم تشيد أي بنية تحتية منذ عشر سنوات، باستثناء مركز البلدية وطريق المطار وبعض الجسور الصغيرة لحركة السير. وهناك بعض الأكشاك التي يقف فيها رجال الشرطة عند تقاطع الطرقات تحمل دمغة “هدية من البلدية”، في منطق يذكر بـ “مكارم” صدام، مما يعني بديلا مما يجب أن يكون سياسة مغفلة. ولا تزال أجور الوظيفة في القطاع العام غير كافية، مما يدفع الموظفين إلى التفتيش عن مصادر دخل إضافية، قانونية أو غير قانونية. والفساد مباح على أعلى المستويات، وموثق، ليستخدم كوسيلة ضغط عند الحاجة. وتعيث بالمؤسسات الانتهازية وتنفيع الأقارب وانعدام الكفاءات.
أكثر من صدام
وقد بات القصر الجمهوري في قلب بغداد، الذي تحول الى “منطقة خضراء” عندما جعل منه الاحتلال الأميركي مركزه العصبي، يجسد أسوأ مظهر من مظاهر النظام الجديد على غرار النظام السابق. فهو في محيطه الواسع الخاضع لحماية أمنية بشكل أو بأخر، بات مجالا سياسيا حصريا، وحيزا للامتيازات، في عالم يبذل كل جهد من أجل الانفصال عن باقي المجتمع.
كل هذا يذكر بما كان في نظر الكثير من العراقيين يشكل حقيقة النظام السابق. والانتقادات التي تصدر عن العراقيين تلتقي في الأساس دائما مع العبارات التي كانت تستعمل سابقا. وليست إقامة المقارنة محرمة، حتى عند الذين لا يريدون بأي ثمن كان العودة إلى الوراء. وهو ما ينطبق على هذا الرجل الذي أكد قائلا: “جاء دورنا الآن. كان صدام واحدا ومتخما. والمشكلة اليوم أنهم باتوا كثرا في الحكم وعندهم جوع مزمن”.
الخروج من المأزق
وفي النهاية، هناك سؤال مؤلم يطرح نفسه: هل أن على العراق أن يتحمل عقدا آخر من المعاناة من أجل لا شيء؟. بالطبع كان سقوط نظام صدام حسين ضروريا من أجل الخروج من المأزق وفتح المجال أمام توزيعة جديدة. فحي الضباط في اليرموك قد وقع في الحرمان، فيما حي الجوادين، البائس فيما مضى، افتتح حديقة أطفال، لا بل من كان ليصدق أنه افتتح أيضا ملعب كرة مضرب. لكن ما هو الثمن المطلوب لتبادل بعض الكرات.. أو حتى بعض المناصب في جهاز الدولة. في الكثير من الأحيان، تبقى الهجرة أو تحقيق الثروة الشخصية هما الأفق الوحيد أمام مجتمع يجاهد من أجل تحديد طموحه الجماعي. النخبة الجديدة ليست مذنبة إلى هذا الحد عن هذا الوضع الذي نتجت أصلا منه، في بلد يبدو الحاضر فيه وليد سلسلة طويلة جدا من الانفصامات.
ولذلك تبدو ذاكرة من يحنون إلى النظام القوي خاوية. فهم لا يتذكرون مثلا المطاردين الذين كان يوظفهم عدي بن صدام، الابن المنحط للطاغية، من أجل الإتيان، من مناطق اصطياف العراقيين، ببنات الأسر الرفيعة لكي يغتصبهن من دون أي عقاب. كان المطلوب هو السير قدما، وهو ما لم يكن بالتأكيد صدام حسين ولا محيطه يملك وسائله ولا النية في تحقيقه. أما اليوم فيجب الأمل في كل شيء، وذلك لأن هناك الكثير للقيام به. الإمكانات والموارد على الأقل متوافرة. والبلد غني بالنفط، علما بأن الفساد يحرص على ألا يكشف عن هذا الثراء بأي شكل. وهجرة الأدمغة يمكن أن تنقلب يوما ما عندما يتغذى جهاز الدولة مجددا بالكفاءات أكثر من إفادة الأتباع والأصدقاء والأقرباء. ويبقى مطروحا أن يخرج البلد من المأزق الجديد في نظام سياسي يبدو التردد فيه شرطا للمؤقت الدائم.